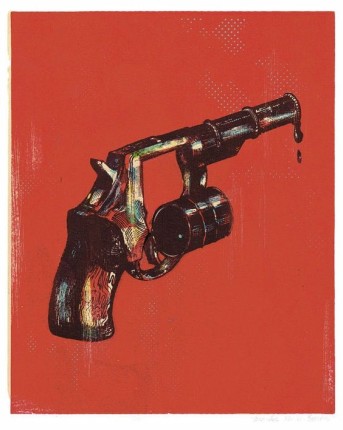
منذ أن اكتشف الرّوس حقول الغاز الضخمة في غرب سيبيريا والأورال ومنطقة «يامال»، قرب الدائرة القطبية، كان هناك همٌّ للأميركيين في منع إيصال هذا الغاز إلى أوروبا الغربية وضخّه إليها في أنابيب. تجد في الأرشيفات الديبلوماسية، منذ أواخر السبعينيات، محاولات أميركية حثيثة لتخريب مشروع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وضغوطات ومؤامرات، ومراسلات مع حكوماتٍ وشركات لثنيها عن المشاركة في تنفيذ خطّ الأنابيب (وصولاً إلى محاولة حرمان الرّوس من الحصول على محرّكات الضخّ والأنابيب العريضة اللازمة لمشروع الغاز، والتي كان يختصّ بها الألمان). تمّ تنفيذ الخطّ، في نهاية الأمر، بنسخةٍ مصغّرة عن الطموح الأصلي، وابتدأ الغاز «السوفياتي» بالوصول إلى أوروبا الغربية في أواسط الثمانينيات. غير أنّ أسعار الغاز يومها كانت منخفضة، واستخدامه لا يزال محدوداً، فلم يصنع الأنبوب فارقاً في المالية السوفياتية أو يغيّر في مسار الاتحاد نحو السقوط. أهمّية الغاز الروسي في أوروبا ستزداد بعد انتهاء الحرب الباردة، مع بناء أنابيب كبيرة جديدة، مثل «يامال» و«نورد ستريم» بنسختيه، التي صمّمت لكي تزوّد أوروبا بقدرٍ من الغاز يفوق انتاج دولة «غازية» كبيرة مثل قطر أو استراليا، وجزءٌ كبيرٌ من هذا الغاز كان يذهب إلى ألمانيا.
هناك قدرٌ من النفاق في اللوم والتقريع الذي يتمّ توجيهه اليوم إلى السياسة الألمانية التاريخية تجاه روسيا، سواء في الداخل أو في أوساط الحلفاء الغربيين، بأنّ ألمانيا تمادت في وصل العلاقات مع موسكو، وجعلتها شريكاً اقتصادياً أساسياً، حتى أصبحت ألمانيا نفسها في حالة اعتمادٍ على «غاز بوتين» يصعب الفكاك منها. الحقيقة هي أنّه ضمن الحلف الأميركي يوجد دوماً «تقسيم عمل»: دولٌ تبقي على علاقاتٍ مع روسيا، تقنعها بالعمل مع الغربيين، وتدمج أسواقها واقتصادها بالفلك الأوروبي. بهذا المعنى، لم تكن برلين في سياستها «الشرقيّة» تتمرّد على حلفائها أو تطعنهم؛ هي استفادت بحكم موقعها من الطاقة الرخيصة والغاز الوفير، ولكن الجسور مع روسيا كانت سياسة غربية عامّة. والعلاقة الألمانية «المميزة» مع روسيا كانت تشبه دور عُمان أو قطر حين يتم تكليفها بفتح قنواتٍ أو لعب دور الوساطة مع دولٍ وقوى غير صديقة لواشنطن. الخطأ الفعلي الذي ارتكبه الألمان هو أنهم لم يتنبأوا بأنّ العلاقة بين روسيا والغرب سوف تصل في نهاية الطريق إلى نقطة القطيعة.
من جهةٍ ثانية، فإنّ الكلام الغربي عن «مقاطعة» روسيا ليس صادقاً بالكامل. يمكن تقسيم العقوبات إلى نوعين: نمطٌ يصيب خصمك وحده (كأن تصادر أرصدته، أو تمنع شركاته عن الأسواق الماليّة، الخ) ونمطٌ يكلّفه ويكلّفك في آن (كأن تمتنع عن شراء الغاز الروسي وأنت لا تملك بديلاً، أو تُجبر شركاتك على ترك روسيا). حزمات العقوبات الغربيّة كانت، حتّى اليوم، من النمط الأوّل أساساً ولكن، حين تصل الكلفة إليهم، تصبح الحسابات مختلفة. دول أوروبا تريد أن توقف شراء النّفط الروسي وأن تقاطعه، ولكنها لا تريد لروسيا أن توقف انتاج نفطها وبيعه. لو تمكّنت العقوبات من تقليص صادرات روسيا بشكلٍِ فعليّ وجدّيّ، سوف تجنّ أسعار النفط فوراً حين تختفي من السوق ملايين البراميل، والدول الغربية اقتصادها أساساً في حالة ركودٍ وتضخّم (من هنا، عبّر مسؤولون أميركيون عن «قلقٍ» من أن يسنّ الأوروبيون عقوباتٍ تحاصر فعلاً الانتاج الروسي وتخرجه من السوق الدوليّة. كالعقوبات الأوروبية على تأمين الناقلات التي تحمل نفطاً روسياً، وجلّ شركات التأمين البحري أوروبي وبريطاني). لهذا السّبب خرج فريق بايدن بمعادلة فريدة: محاولة لوضع سقف على سعر برميل النفط الروسي الذي يشتريه المستوردون، فلا تهتزّ الأسواق العالمية وتتقلّص -في الوقت ذاته- العائدات الروسية من بيع نفطهم. من هنا أيضاً تجد رئيساً مثل إردوغان هو في الـ«ناتو» وبلده يدعم الحرب الغربية في أوكرانيا بأشكالٍ مختلفة ولكنه، في الوقت نفسه، يشتري الغاز والنفط من روسيا، ويلتقي في مؤتمراتٍ ببوتين، ولا يوجّه له حلفاؤه أي انتقاد. هم يعرفون أنّه «يجب» أن يشتري أحدٌ ما هذا الغاز الرّوسي، وإلا لقفزت الأسعار في القارة إلى مستوياتٍ قياسية جديدة حين يتزاحم الجميع لشراء الغاز المسال - الذي لا توجد طاقة احتياطية لانتاجه يمكن أن تستبدل، الآن أو في السنة القادمة، امدادات الأنابيب الروسية إلى أوروبا. في الخلاصة، الحافز عند الغربيين هو في أن يرفعوا كلفة العقوبات على روسيا إلى الحدّ الأقصى مع تقليل تأثيرها عليهم إلى الحدّ الأقصى (ولو كان ذلك بثمن شراء طاقةٍ روسية، أو اتاحة بيعها في السوق الدولي)، والحافز عند موسكو هو ألّا تسمح بإرساء مثل هذه المعادلة، وهنا جوهر الحرب الاقتصادية التي تشنّ ضدّ روسيا.
أبعد من الاستيلاء
الأساس الذي يجب الانطلاق منه هو أنّ الطاقة ليست مجرّد «سلعة» لها سعرٌ وثمن. «مصادر الطاقة» التي نستخدمها هي عبارة عن عمليّة تطويع أو تحويل أو تسييل للطبيعة من حولنا (سواء كانت طاقة الشمس، أو الماء، أو الطاقة التي اختزنتها الأرض في جوفها على شكل مواد كاربونية، أو طاقة الذرّات، الخ)؛ وكلّ عهدٍ جديدٍ من عهود الطاقة كان ينتج تنظيماً اجتماعياً جديداً، وعلاقة مختلفة بين الانسان وبيئته. حين نتكلّم على الثورة الصناعية ونقل قدرة الانتاج من الانسان إلى الآلة، فإنّ هذه الآلات لا تتحرّك بالسّحر، بل عبر مصادر الطاقة الجديدة التي طبعت العصر الصناعي. حتى بداية القرن العشرين، مثلاً، كان الامتياز التفاضلي في الصناعة والطاقة جغرافياً إلى حدٍّ بعيد: في سياق القرن التاسع عشر، إن لم تكن تمتلك غاباتٍ واحتياطاتٍ من الفحم والحديد، فكيف ستنتج الفولاذ وتبني سكك حديد وتحقّق «نهضة صناعية»؟ ميزة عصر النفط، كما يقول تيموثي ميتشل، هو أنّ النفط يمثّل الشكل السائل للطاقة: يمكن تخزينه ونقله بسهولة، حمولة سفينة واحدة منه تكفي لاضاءة مدينة كبيرة لأسابيع، ويمكن وضعه في محرك الاحتراق الداخلي الذي يسيّر المركبات والطائرات وباقي أدوات الانتاج والنقل في العصر الحديث. منذ أقلّ من قرنٍ فقط أصبحت الطاقة سلعة «عالمية» لها سعرٌ متقارب ويمكن نقلها وشراؤها، وبناء نموذج تنموي على طاقة لا تنتجها من أرضك.
من هذا السياق أيضاً خرجت «حروب الطاقة» بالشكل الذي نعرفه اليوم، إذ أصبحت السيطرة على منابع النفط، أو استخراجه، أو تسعيره، تعني التحكّم بمصدر طاقة يعتمد عليه -جماعياً- أغلب أهل الأرض. توجد هنا فكرةٌ رائجة، تبسيطية، عن هدف القوى العظمى من موارد دول الجنوب؛ فكرة أن أميركا تريد «سرقة النفط» مثلاً (كما كان يعبّر دونالد ترامب، بسذاجة وصراحة، «لماذا لم نأخذ نفط العراق؟»). الإمبراطوريات، منذ زمنٍ بعيد، لا تعمل عبر الفكرة البدائية للنهب والاستيلاء. الفكرة هي أنه مع تحويل الطاقة إلى سلعةٍ سوقيّة، لا يصبح المهمّ هو أن تمتلكها، بل أن تقرّر بنية السوق الذي تُعرض فيه وتُباع، والعملة التي تسعّر بها، وأن «تحمي» طرق نقلها ومعها -إن أمكن- الأنظمة في الدّول التي صادف أنّ النفط قد تكوّن ضمن حدودها. كتب الإيطالي ماركو دي رامو مؤخّراً في «نيو ليفت ريفيو» ليشرح أن نمط الهيمنة الحالي في العالم يقوم على هندسة الأسواق المالية وتقرير قواعدها، وليس حيازة رأس المال نفسه. هذا يجري على مادة كالنفط والغاز، فقيمتها وأهميتها الفعلية هي ليست في بيع «السلعة» نفسها بصيغتها الخام، بل بالناتج الاقتصادي الذي يأتي من نقلها واستهلاكها في اقتصادٍ آخر (على سبيل المثال، لو أنّ بلداً أفريقياً فقيراً وجد احتياطاتٍ صغيرة من الغاز في أرضه، لا تكفي للتصدير ولن تنتج ربحاً، فلن تأتي أي من الشركات العالمية لاستخراجها وستظلّ غير مستغلّة، وإن كان البلد نفسه يحتاجها بشدّة.
ما كان ينطبق على النفط في القرن العشرين أصبح ينطبق، إلى حدٍّ ما، على الغاز حين زاد استخدامه وراجت صناعة تسييله ونقله بالسّفن إلى أقاليم بعيدةٍ ودولٍ جزريّة لم يكن الوصول إليها متاحاً عبر الأنابيب. وأوروبا، وألمانيا تحديداً، قد «صمّمت» سوق الغاز بشكلٍ يعطيها امتيازات وأفضلية (وهنا معنى «الريع الإمبراطوري»). أصبح الغاز الرخيص، من روسيا ومن شمال أفريقيا ومن بحر الشمال، دعامة أساسية للاقتصاد الأوروبي، وأصبح في وسع دولٍ لم تعطها الطبيعة موارد كاربونية أن تنافس في مجالاتٍ تحتاج إلى الطاقة بكثافة. قد يستغرب البعض لماذا يحتاج المواطن في بعض دول العالم الثالث، رغم فارق الدخل، إلى دفع فاتورةٍ لـ«مولّد خاص» تفوق فاتورة الكهرباء لمنزلٍ كبيرٍ في أميركا، ومعه سيارة كهربائية، ولكن هنا مغزى الامتياز التنافسي الذي تؤمنه دول المركز لشركاتها ونخبها وشعبها. قد تتمكّن أوروبا الغربية، نظرياً، من بناء محطات استقبالٍ للغاز المسال واستبدال الغاز الروسي به، خلال سنتين مثلاً، ولكن الثمن المرتفع للغاز المسال سوف يرفع من كلفة الطاقة بشكلٍ عام، ويخفض من تنافسية الاقتصاد، وقد يخرج بعض القطاعات (كالبتروكيمياويات التي تعتمد على الغاز) من السوق بشكلٍ كامل. في الوقت نفسه، بدلاً من الوصول إلى امداداتٍ وفيرةٍ مضمونة، يصبح امداد الغاز وسعره في أوروبا مرتبطين بأوضاعٍ عالمية لا يمكن التحكّم بها: شتاءٌ بارد، انخفاض في انتاج الغاز الصخري في أميركا، حربٌ في الخليج.
بالمعنى المعاكس، لو انتصر الحلف الغربيّ وثبّت هيمنته في السياسة والأسواق والاقتصاد، وجمع أكثر العالم حوله، وتمكّن من عزل روسيا واضعافها، فإنّ «التأقلم» سيحصل، وإن بعد سنوات: ستعيد أوروبا هندسة خريطة الغاز لصالحها، وتحصل على طاقة رخيصة من غرب أفريقيا أو شمالها أو مكانٍ آخر. سوق الطاقة تقرّره السياسة؛ والكلفة هنا ليست كبيرة كما يتصوّر البعض فالعقوبات على روسيا، في نهاية الأمر، ليست إلّا مقدّمةً لمواجهةٍ قادمة ستكون أكبر وأصعب وأكثر كلفةً بكثير، عمليّة «الانفصال الكبير» (decoupling) عن الصّين، والتي قد انطلقت بالفعل.
طاقاتٌ مهدرة
لأنّ الطاقة، إذاً، هي مادّة «سياسيّة»، فإنّها في بلدٍ من بلادنا تعكس مستوى السيادة فيه وقدرة البلد على التحكم بثروته والتخطيط لمستقبله. في بلدٍ مثل لبنان، سُحر الجميع منذ سنوات باحتمال وجود احتياطات نفطٍ وغازٍ أمام السواحل، لأنها «سلعٌ» يمكن تسويقها لأوروبا. المفارقة هي أنّه، بينما يتمّ اقتراح كلّ أشكال الخطط لإنعاش الاقتصاد اللبناني وحلّ «أزمة الكهرباء»، قلّةٌ تشير إلى موقعٍ لـ«الانتقال الطاقوي» في مستقبل البلد. المسألة هي أنّ الموضوع بديهي: لبنان هو من أكثر الدّول التي ينجح فيها سيناريو «الانتقال» إلى استخدام الطاقة المتجدّدة، لأنّ الوضع الأوّلي الذي ننطلق منه فاشلٌ وغير فعّال بصورةٍ فائقة، وكلفة الطاقة من الأعلى في العالم (فيما بلادٌ لديها، أصلاً، أنظمة ناجحة لانتاج الكهرباء تقوم باستبدالها بالطاقة الطبيعية). كلفة الطاقة المتجددة أصبحت تنافسيّة وهي لن تنخفض بشكلٍ كبيرٍ بعد اليوم. لبلد يحتاج أصلاً إلى استثماراتٍ وتشغيل وهذه فرصةٌ لذلك، فـ«الانتقال» إلى نمطٍ يعتمد (وإن بشكل جزئي) على الطاقة المتجدّدة يحتاج إلى مشاريع توليد على مستوى كبير ووطني، وهذا في بلادنا لا تقدر على تنظيمه وتخطيطه غير الدّولة.
اكتشف اللبنانيون، تحت ضغط الحاجة، ضرورة اللجوء إلى طاقة الشمس وبدأوا بتركيب الأنظمة الشمسية - كما في الكثير من دول العالم الثالث - بشكلٍ فرديّ لمن يقدر على احتمال كلفته، وهي منهجية مكلفة وغير آمنة وغير فعّالة (الكثير من الطاقة التي يمكن انتاجها، مثلاً، يُهدر فائضاً بدلاً من أن يُباع إلى الشبكة الوطنية). دول شرق المتوسّط مثل سوريا ولبنان فيها أفضل الظروف لتوليد الطاقة الشمسية، ولبنان فيه مساحات كبيرة غير مستخدمة، في أعالي الجبال، يمكن أن تولّد طاقة تكفي لعدّة دولٍ بحجم لبنان (والجرود التي تنخفض فيها الحرارة ولكنها تنعم بالشمس قد تكون، على عكس ما يتصور البعض، مثالية لتوليد الطاقة الشمسية أكثر من الساحل القريب). هناك فارقٌ أساسي بين الطاقة المتجددة وبين الموارد التقليدية للطاقة؛ لو أنّك اشتريت برميلاً من النفط وأحرقته في أيّ بلد، فهو سينتج القدر ذاته من الطاقة (الفارق الوحيد سيكون في كلفة النقل)، ولكن عدد ساعات الشمس في بلدٍ من دول الجنوب قد يفوق ضعف عددها في ألمانيا، بمعنى أن الاستثمار ذاته ينتج ضعف المردود.
الشمس مثل النفط، موردٌ وطنيّ؛ ولكنك لن تجد الحماسة نفسها لمثل هذه الاحتمالات، حتى حين تكون واضحة وبديهية ولا تحتاج إلى ابداعٍ وخيال، مقابل حمّى «الذهب الأسود»: سلعةٌ يمكنك أن تستخرجها وتبيعها للسوق الدولي، بسهولةٍ ومن غير بنى تحتية وتخطيطٍ ونموذجٍ تنموي. تجد اهتماماً أوروبياً بالطاقة الشمسية في شمال أفريقيا فقط حين يربط الموضوع بالتصدير إلى أوروبا، أي تحويل الشمس في هذه البلاد إلى سلعةٍ يتمّ تسويقها دولياً، ومصدراً جديداً لشراء الطاقة الرخيصة.
الغاز اللبناني، بالمناسبة، إن تحقّق وجوده، لن يكون مصدراً سهلاً للدولارات كما يتصوّر الكثيرون. قد لا تكون الكميّات كبيرة، تبرّر مدّ أنابيب في المياه العميقة لتصديره، أو بناء معامل مكلفة لتسييله. والخيار «المنطقي» تجارياً لتصدير أيّ غازٍ لبناني إلى أوروبا هو عبر أنبوب شرق المتوسّط المقترح، والذي تقوده إسرائيل. رأيي، الذي شرحته سابقاً، هو أنّ فرصتنا الحقيقية مع الغاز، إن خرج من أرضنا، هو أن «نشتريه» بأنفسنا ونستخدمه لانتاج كهرباءٍ للبلد بكلفة قليلة وكمادة أولية للصناعة، وهذا سيكون أفضل استخدامٍ له (وإن كان هناك فائضٌ لا بدّ من تصديره فالمنطقي أن يذهب إلى الدول المحيطة القريبة، سوريا والعراق وتركيا). حين يتكلّم الكثيرون عن سياسات «سحرية» ستعيد انعاش اقتصادنا، أو تحوّلنا إلى «الاقتصاد المنتج»، أو تجعلنا بلداً مصدّراً وتايواناً جديدة، فهم لا يقدّرون أن أموراً كهذه تبدأ من تصوّر منظومةٍ تنافسية وواقعيّة للطاقة والنقل وما شابه، هي البنية التحتيّة لأي نشاطٍ اقتصاديّ. وبالنسبة للغاز، فإنّ استخراجه في ظروفٍ كمياه المتوسّط تحتاج إلى شركاتٍ عالميّة، و«توتال» وأمثالها لن تأتي إلى لبنان من غير ضماناتٍ واتفاقاتٍ سياسيّة. وطالما أنّ لبنان لم يسر مع التطبيع، فإنّ السيناريو الأقرب إلى العقل هو أن «يجرجرونا» -إن اعتمدنا عليهم- لسنواتٍ بحججٍ شتّى من غير أن يحصل استثمار أو انتاج؛ وسراب الغاز في هذه الحالة يصلح أيضاً لاستجلاب التنازلات والاغواء بالتطبيع.
خاتمة: «دور الدّولة»
في الخطاب الشعبوي موقعٌ مركزيٌّ وسحريّ لكلمة «الدولة». «لو كان لدينا دولة لما حصل هذا»، «في البلاد التي فيها دولة…»، الخ. المشكلة في هذا الخطاب هي أنّه حين يتكلّم عن الدّولة، فهو يفترض نمطاً محدّداً مثالياً عنها (الدولة في السّويد مثلاً)، وأنّ كلّ ما عداه هي أشكالٌ «مزيّفة». وهو في الوقت ذاته لا يقدّم تعريفاً وظيفياً لهذه الدولة إلا باعتبارها الفاعل الايجابي، صندوقٌ أسود يقدّم له كلّ ما ينقصه. كلّ هذه النماذج في الواقع، من أميركا لنيجيريا للعراق، هي أمثلة «حقيقية» عن الدّولة، وتكون «الدولة» من أسباب شقاء البلد، وليست «ما ينقصه».
بالنسبة إلى الاقتصادي مايكل هدسون، كان الدّور الفعلي للدولة في العديد من الحضارات القديمة يرتكز على منع «الاستيلاء على المجتمع». بمعنى أنّ السّلطة، غالباً بتكليفٍ إلهي، تضمن أن لا تصبح الأرض كلها في يد فئةٍ قليلة، وأن لا يتمكّن التجّار من مراكمة الديون على الجميع والتحوّل إلى أوليغارشيا، وأن لا يتمكّن أحدٌ من جمع السلطة المالية بالسلطة السياسية (مؤسسات الدولة والمعبد، يكتب هدسون، كانت تقرض السّوق في بابل واشور، ولا تقترض منه، فكانت لا «تحتاج» إلى من يموّلها ولا يمكن أن تقع تحت سيطرة الدّين والدائنين؛ بل كانت من وظائفها الالغاء الدّوري للديون أو تأجيل دفعها في سنوات القحط، وإعادة توزيع الأرض حين تسيطر قلّة على ملكيّات كبيرة). النظام الليبرالي التمثيلي مقروناً بالسوق الحرّ، يحاجج هدسون، يزيح كلّ الحواجز التي كانت تمنع سلطة القلّة من أن تتزايد بلا حدود، من غير أن تستبدلها بديموقراطيّة وتمثيل شعبي حقيقيّين. ووصفات «التحديث» التي راجت بين دول الجنوب في العقود الماضية (من تحرير السوق إلى الاصلاحات المؤسسية والانتخابات الصوريّة)، كانت في جانبٍ أساسي منها وسائل لتمكين الاختراق الخارجي، بالترافق مع صعود فئاتٍ محليّةٍ محظيّة، تتشارك مع رأس المال الدولي وتراكم سلطتها في المجتمع من غير عوائق.
الفكرة هنا هي أنّ «الدّور الفعلي» للدولة، أو ما يفرّق دولةً عن أخرى في العمق، هو قدرتها على حماية المجتمع وموارده من الاستيلاء، سواء من الدّاخل أو من الخارج. نقاش «الداخل والخارج» هنا عقيم، فالمقولة الشهيرة في العلاقات الدولية هي أن الأمن يأتي أوّلاً لأنّ لا ازدهار من غير أمن، فيما هدف الأمن والسيادة -في نهاية الأمر- هو تأمين استقرارٍ ومراحل سلامٍ غير منقطعة، يمكن للمجتمع خلالها المراكمة وتحقيق الازدهار (و، بالتجربة، من لا يؤتمن على سيادة بلده وأمن مواطنيه لن يعفّ عن موارده وثرواته). إن كان المفهوم البدائي للدولة هو أنها الكيان الجماعي الذي ينظّم النّاس، فإنّ النّاس يتنظّمون أوّلاً للدفاع عن أنفسهم وعن ملكيّتهم المشتركة وحرّيّتهم، فلا يخرج عليهم من يحتلّ أرضهم من الخارج، أو يحتكرها في الداخل، أو يكبّلهم بالديون و«يشتريهم» بثروته. من هنا تخرج «الوظائف» الأخرى -«التقنية»- كالتخطيط والتنمية واستغلال الطاقات ويصبح لها سبب وهدف. وفي نهاية المطاف، وبخاصّة في زمنٍ «خطيرٍ» و«فاسد» كزمننا، فإنّ الدّولة الموجودة، إن لم تتمكّن من أداء هذا الدّور للناس، يصبح من يؤدّيه هو الدولة.


 02 اغسطس, 2022
02 اغسطس, 2022 3220
3220 


 مساحة حرة
مساحة حرة الأكثر قراءة
الأكثر قراءة الأكثر تعليقاً
الأكثر تعليقاً

























